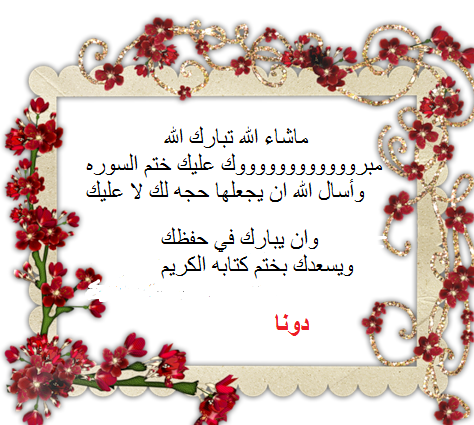دونا
•
امين امين ولك بالمثل..
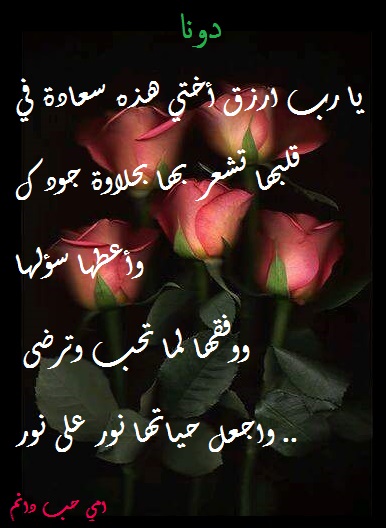
دونا
•
بسم الله راجعت اخر وجهين من سورة الحجر والحمد للهبسم الله راجعت اخر وجهين من سورة الحجر والحمد لله
طهر ( الله ) قلبك ..
وأزاح ( الله ) همك ..
وغفر ( الله ) ذنبك ..
وكثر ( الله ) أحبابك ..
وبارك ( الله ) عملك ..
وفرج ( الله ) كربك ..
وأصلح ( الله ) أهلك ..
وسدد ( الله ) رأيك ..
وبارك ( الله ) في يومك وغدك بإذن الله تعالى
وأزاح ( الله ) همك ..
وغفر ( الله ) ذنبك ..
وكثر ( الله ) أحبابك ..
وبارك ( الله ) عملك ..
وفرج ( الله ) كربك ..
وأصلح ( الله ) أهلك ..
وسدد ( الله ) رأيك ..
وبارك ( الله ) في يومك وغدك بإذن الله تعالى

آية (59):
* بعض الآيات التي تتكلم عن لوط تأتي (قوم لوط) أو (إخوان لوط)أو(آل لوط) فماالفرق بين
قوم وإخوان وآل؟(د.حسام النعيمى)
الفرق اللغوي:قوم الرجل هم أهله بالصورة الواسعة يقال فلان من قوم كذا، وقد يكون القوم أوسع من القبيلة،
العرب قوم.والقوم إسم جمع مثل شعب وجيش ليس له مفرد من جنسه .الآل هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس ومن معانيه الزوجة و الأتباع، الذرية أوالأقارب ، لكن قوم أوسع.الإخوان أقرب من الآل لأن الآل قد يكون فيها الأتباع (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) غافر) أي أتباعه.
بالنسبة لآل لوط لم تستعمل إلا في الثناء عليهم فقط، لما يثني عليهم لا يستعمل كلمة قوم.
القرآن الكريم يستعمل كلمة قوم وأحياناً كلمة آل وأحياناً كلمة إخوان. مثلاً عندنا قوم نوح وقوم فرعون وقوم موسى
وقوم ابراهيم وقوم اسماعيل وقوم هود وقوم لوط وقوم صالح وقوم تُبّع، وورد أخاهم هوداً وأخاهم صالحاً وأخاهم شعيباً وعندنا أخوهم نوح وهود وصالح ولوط، وعندنا إخوان لوط، إخوة يوسف، إخوان الشياطين. كل واحدة في مكانها. الإخوة ذكرت لشعيب وهود وصالح ولوط ونوح في حال الرفع والنصب.
آية (60):
*ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين قوله تعالى في سورة النمل (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57)) وفي قوله في سورة الحجر (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)) في قصة امرأة لوط؟
د.فاضل السامرائى:
لونظرنا إلى آية سورة الحجر (إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60))
لوجدنا فيها ستة مؤكدات هي: (إنّا، اللام في لمنجوهم، منجوهم (إسم)، أجمعين، إنّ في إنها واللام في لمن الغابرين) ثم أننا إذا نظرنا في السورة كلها أي سورة الحجر لوجدنا فيها 20 مؤكد في قصة لوط بينما في سورة النمل ففيها ثلاثة مؤكدات فقط في القصة كلها (أئنكم، لتأتون، وإنهم أناس يتطهرون). هذا الجو العام في السورتين
والوضع الوصفي فالآية في سورة الحجر أنسب مع الؤكدات في القصة من آية سورة النمل. وقد يسأل السائل لماذا؟ نلاحظ أنه تعالى وصف قوم لوط في سورة الحجر بالإجرام (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58)) أما في النمل فوصفهم بالجهل (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55))
والمجرمون أشد من الجاهلين فالوضف أشدّ وهذا الوصف الأشدّ يقتضي عقوبة أشدّ ول نظرنا إلى العقوبة في كلتا السورتين لوجدنا أن العقوبة في سورة الحجر أشدّ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)) وفي سورة النمل (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58))
والمطر قد يكون ماء أما الحجارة في سورة الحجر فهي بالطبع أشدّ. إذن العقوبة أشدّ والوصف أشدّ ثم إن القصة في سورة الحجر (19 آية من الآية 58 إلى 76) أطول منها في سورة النمل (5 آيات فقط) فإذا نظرنا إلى القصة من جهة التوسع والإيجاز فآية سورة الحجر أنسب ومن حيث التوكيد والعقوبة والطول أنسب ولا يناسب وضع الآية مكان الأخرى. القرآن الكريم يراعي التعبير في كل مكان بصورة دقيقة ويراعي التصوير الفني للقصة.
د. حسام النعيمى:
في قوله تعالى في سورة الحجر الكلام كان على لسان الملائكة (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51)إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52)) الجو العام جو وجل وخوف من إبراهيم وتشكك، (قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53)قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54)قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55))
لا تيأس من رحمة الله (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56)) (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)) لاحظ التأكيدات هو يحتاج لمؤكدات لأنه وجل وشاك من الملائكة. تأكيد بإنّ وباللام. كلام الملائكة
لاحظ كلمة(قدرنا) هم لا يقدرون ولكن لأنهم وسيلة تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى رخصوا لأنفسهم أن يقولوا قدرنا ولكن ما قالوا قدرناها لم يربطوا الضمير بالتقدير، بأنفسهم لذلك أبعدوها مع وجود إنّ المؤكدة. فإذن كلام الملائكة يحتاج إلى تأكيد وإبتعد ضمير المفعول به في الأصل. الأصل هي قدرنا لكن أدخلوا إنّ فأبعدوها عن التقدير.
الآية الثانية هي من كلام الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النمل (فما كان جواب قومه فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) النمل) (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) خبر، (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ) ما قال قدرنا إنها،ما احتاج إلى تأكيدات لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأمر: بأن قوم لوط أجابوا بهذه الإجابة فالله سبحانه أنجاه وأهله إلا امرأته قدرها رب العزة من الغابرين.
وأُنظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشرة ما أبعده (قدرناها) لأن هذا قدره سبحانه وتعالى فما إحتاج إلى إبعاده. الغابرين قالوا بمعنى الباقين الهالكين الذين بقوا في الهلاك. نهاية الآية تفسر لنا كلمة (كانت) لما قال (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) )انتهى الكلام على ذكر الأمم، كان آخر شيء في ذكر الأمم يعني
لم تكن هناك حكاية ورواية لأمور وإنما رواية لهذه المسألة. النهاية كانت (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59)) لم يذكر أمة أخرى وراءها. هو لا يتحدث حديثاً تاريخياً متواصلاً وإنما إنقطع الكلام هنا.
آية (61):
*ما الفرق بين استعمال جاء وأتى في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى)
قال تعالى (فَلَمَّا جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ {61 الحجر}) وقال تعالى (يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً {43}مريم) وقال تعالى (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} الإنسان).
إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضارع للفعل جاء مطلقاً في القرآن كله ولا صيغة فعل أمر ولا إسم فاعل ولا إسم مفعول وإنما استعمل دائماً بصيغة الماضي. أما فعل أتى فقد استخدم بصيغة المضارع.
من الناحية اللغوية: جاء تستعمل لما فيه مشقة أما أتى فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر ومنه الالمتياء وهي الطريق المسلوكة.
*ما دلالة الحروف (بما) و(لوما) في الآيات القرآنية؟(د.فاضل السامرائى)
(بما) للسبب وتقال للقسم أيضاً والسبب أظهر كما قال تعالى (رب بما أغويتني) أي بسبب ما أغويتني.
(لوما) إما أن تكون حرف امتناع لوجوب عندما تدخل على الأسماء أو يكون من حروف التحضيض عندما تدخل على الأفعال (لوما يأتينا بآية).
*هل يحق لنا استخدام كلمة (لعمري) الذي استخدمت في القرآن (لعمرك)؟ (د.فاضل السامرائى)
القسم بغير الله لا يجوز لكن يُسأل عن هذا السؤال فقيه لأنه من باب الحلال والحرام. وفي الحديث لا يجوز القسم بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
آية (68):
*في سورة الحجر (قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ (68)) وفي الذاريات (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24)) كلمة ضيف جاءت بالمفرد مع أن الملائكة مكرمين يعني جمع؟ (د.فاضل السامرائى)
كلمة ضيف تقال للمفرد وللجمع في اللغة مثلها كلمة خصم تقال للمفرد وللجمع (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) ص) وهذه ليست مختصة بالإفراد. وكذلك كلمة طفل تأتي للمفرد وللجمع عندنا كلمات في اللغة تأتي للمفرد وللجمع. وكذلك كلمة بشر (فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ (24) القمر) مفرد (بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ (18) المائدة)
جمع. عندنا كلمات تكون للمفرد وللجمع منها كلمة ضيف تكون للمفرد وللجمع. عندنا ضيوف وأضياف وعندنا خصم وخصوم وطفل وأطفال ورسول أيضاً تستعمل مفرد وجمع، ورسل، رسول جمع أيضاً تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمصدر أيضاً وهذا يسمى في اللغة إشتراك. الرسول تأتي بمعنى الرسالة والإرسال، المبلِّغ هذا الأصل فيها (فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) الشعراء) (فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ (47) طه) فإذن ضيف تأتي مفرد وجمع.
آية (74):
*ورد وصف عذاب قوم لوط مرة أنه وقع على القرية ومرة على القوم (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ (82) هود) (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74) الحجر) فما الفرق بينهما؟(د.فاضل السامرائى)
في الحجر (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ) وفي هود (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا) عليها يقصد بها القرية وعليهم يقصد بها الناس والقوم.عليهم يعني القوم وعليها يعني القرية يبقى سبب الاختيار. لا شك أنه لما قال عليهم معناها القوم وعليها يعني القرية يبقى سبب الاختيار هذا هو السؤال. لو لاحظنا الكلام على القوم في الموطنين كيف كان يتحدث حتى نفهم سبب الاختيار سنلاحظ أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود ووصفهم بصفات أسوأ مما في هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود: قال في الحجر على لسان الملائكة (قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (58))
وفي هود (إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70))، وفي الحجر قال (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (66)) وفي هود (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76)) العذاب هنا لا يقتضي الإستئصال أما في الحجر فهناك استئصال فما في الحجر إذن أشد مما في هود. أقسم على حياة الرسول في الحجر على هؤلاء
فقال (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)) ولم يقسم في هود. إذن ما ورد في الحجر في قوم لوط أشد مما ورد في هود وصفهم بالإجرام وأنه سيتأصلهم وأنهم في سكرتهم يعمهون فذكرهم هم (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً) ذكرهم هم ولم يذكرهم في هود فلما ذكرهم هم قال وأمطرنا عليهم ولما لم يذكرهم قال وأمطرنا عليها هذه أخف. أمطرنا عليهم أشد من أمطرنا عليها ذكر فأمطرنا عليهم في مقام الشدة والصفات السيئة.
*هل الماء والغيث كلاهما مطر؟ (د.فاضل السامرائى)
المطر يستعمله الله سبحانه وتعالى في العقوبات (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) الأعراف) لم يستعمل القرآن المطر إلا في العقوبة (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ (40) الفرقان) (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74) الحجر) (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (173) الشعراء)
أما الغيث فيستعمله في الخير. هذا في الاستعمال القرآني أما في الحديث فاستعمل المطر للخير ولكن للقرآن خصوصية في الاستعمال اللغوي نخصص لها إن شاء الله تعالى حلقات لنتحدث عنها لأنه موضوع كبير. والعرب فهمت هذا الفرق من الاستعمال. (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) الشورى). إذن في القرآن الكريم يذكر المطر للعذاب.
آية (75)-(77):
*قال تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75) و( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ (77) ما الفرق بين استخدام الجمع في الأولى والمفرد في الثانية. ثم انتقل إلى المثنى بعد الجمع(فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)؟(د.فاضل السامرائى)
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75)) هذه ذكرها تعقيباً على قوم لوط وذكر فيها عدة أمور قال (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73)) هذه آية، (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا (74)) هذه آية أخرى، (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ) هذه آية أخرى إذن هي آيات وليست آية واحدة لأن كل واحدة منها آية. والآية يعني العلامة والمتوسمين هم المفكرين المتفرسين والمعتبرين. في سياق القصة ذكر عدة أمور وعدة آيات وليست آية واحدة ذكر الصيحة وذكر عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة ثم قال (وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ (76))
أي الآن الآثار فقال (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ (77)) عندما تكلم عن الآثار هي آية واحدة (لآية) أما تلك فهي آيات. أما قوله تعالى (وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)) تكلم بعدها عن أصحاب الأيكة، إنهما أي قوم لوط وأصحاب الأيكة في طريق واحد تمرون عليهم. إمام أي طريق، تمرون عليهم بعد سنين أصحاب الأيكة وقوم لوط.
آية (82):
*(وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) الحجر) (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) الشعراء) ومرة ينحتون الجبال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (74) الأعراف)؟ فمتى نستخدم (من) ومتى لا نستخدمها؟ (د.فاضل السامرائى)
نقرأ الآيتين إحداهما في الأعراف والأخرى في الشعراء، قال في الأعراف (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74)) هؤلاء قوم صالح، في الشعراء قال (أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آَمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150)) نلاحظ في الأعراف مذكور فيها التوسع في العمران (تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا)
بينما في الشعراء الكلام عن الزرع وليس عن البناء، الكلام يدل على الزراعة أكثر (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148)) إذن في الأعراف السياق في العمران أكثر وفي الشعراء السياق في الزراعة فلما كان السياق في الأعراف في العمران ذكر (تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا) ذكر القصور وقال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) كأنها كل الجبال ينحتونها بيوتاً فتصير كثرة بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149)) صار أقل (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ) أقل من (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا)
لذلك قال في آل عمران (فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74)) إذن التوسع في العمران في الأعراف أكثر فلما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع قال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) ولما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149)).
آية (88):
*ما الفرق بين فعلى الأسى والحزن؟ (د.فاضل السامرائى)
كِلا الفعلين يدل على الحزن عندنا حزِن يحزَن وحزَن يحزُن، حزِن يحزَن فعل لازم ليس متعدياً تقول حزِن عليه و(وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (88) الحجر)، (فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ (76) يس) (الكاف مفعول به).حزِن يحزُن متعدي، حزنني وأحزنني (قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ (13) يوسف). اللغة العليا حزَن يحزُن وتستعمل أحزن أيضاً، أحزن من حَزَن. الفعل أسي يأسى يسمونه الباب الرابع (لكيلا لا تأسوا) وأسى بمعنى حزن أيضاً (فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) الأعراف)
هي أأسى، فهو أسي يأسى، كلاهما يفيد الحزن لكن الفارق بين لكيلا تحزنوا ولكيلا تأسوا في الحزن مشقة أكثر وشدة لأنه قريب من معنى الحزْن الذي هو الغلظ والشدة في الأرض (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزْن إذا شئت سهلاً) الحزْن أي الصعب وتقال للأرض الصعبة. إذن الحزن فيه غِلظ وشدة في الأرض
والحُزن هو الغلظ والشدة في النفس. أيهما أثقل؟ الحُزن أثقل على النفس من الحزْن ، الحزْن تجتازه وانتهى الأمر أما الحُزن فيبقى في النفس. الحَزن فتحة والحُزن ضمة فاختاروا الضمة لما هو أثقل لأنها تتناسب اللفظة مع مدلولها أو المعنى .
آية (92):
*كيف نوفق بين الآيتين(فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) الرحمن) (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) الحجر)؟(د.فاضل السامرائى)
هذه مواقف مختلفة يوم القيامة الموقف الأول أنهم لا يُسألون مطلقاً ثم يصير السؤال، الموقف الأول خمسين ألف سنة لا يُسألون هذا الموقف قبل الحساب ثم يكون الحساب والسؤال (لنسألنهم أجمعين).
آية (98):
*د.فاضل السامرائى:
في القرآن نلاحظ أن الله تعالى يأمر بالإكثار من التسبيح والذكر في المواطن التي تحتاج إلى صبر وفي الأزمات (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) الحجر) وأمره بالتسبيح في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) الأنفال)
ومداومة التسبيح تفرّج الكروب كما جاء في قصة يونس وهو في بطن الحوت (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) الصافات)
فالذي نجّى يونس من بطن الحوت هو مداومته على التسبيح (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)) والتسبيح وذكر الله هي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك. فهو ترتيب منطقي جداً بعدما تضيق الصدور والقلوب نذكر اسم ربنا.
* بعض الآيات التي تتكلم عن لوط تأتي (قوم لوط) أو (إخوان لوط)أو(آل لوط) فماالفرق بين
قوم وإخوان وآل؟(د.حسام النعيمى)
الفرق اللغوي:قوم الرجل هم أهله بالصورة الواسعة يقال فلان من قوم كذا، وقد يكون القوم أوسع من القبيلة،
العرب قوم.والقوم إسم جمع مثل شعب وجيش ليس له مفرد من جنسه .الآل هم الأهل المقربون الذين هم أقرب الناس ومن معانيه الزوجة و الأتباع، الذرية أوالأقارب ، لكن قوم أوسع.الإخوان أقرب من الآل لأن الآل قد يكون فيها الأتباع (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) غافر) أي أتباعه.
بالنسبة لآل لوط لم تستعمل إلا في الثناء عليهم فقط، لما يثني عليهم لا يستعمل كلمة قوم.
القرآن الكريم يستعمل كلمة قوم وأحياناً كلمة آل وأحياناً كلمة إخوان. مثلاً عندنا قوم نوح وقوم فرعون وقوم موسى
وقوم ابراهيم وقوم اسماعيل وقوم هود وقوم لوط وقوم صالح وقوم تُبّع، وورد أخاهم هوداً وأخاهم صالحاً وأخاهم شعيباً وعندنا أخوهم نوح وهود وصالح ولوط، وعندنا إخوان لوط، إخوة يوسف، إخوان الشياطين. كل واحدة في مكانها. الإخوة ذكرت لشعيب وهود وصالح ولوط ونوح في حال الرفع والنصب.
آية (60):
*ما اللمسة البيانية في الاختلاف بين قوله تعالى في سورة النمل (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57)) وفي قوله في سورة الحجر (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)) في قصة امرأة لوط؟
د.فاضل السامرائى:
لونظرنا إلى آية سورة الحجر (إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60))
لوجدنا فيها ستة مؤكدات هي: (إنّا، اللام في لمنجوهم، منجوهم (إسم)، أجمعين، إنّ في إنها واللام في لمن الغابرين) ثم أننا إذا نظرنا في السورة كلها أي سورة الحجر لوجدنا فيها 20 مؤكد في قصة لوط بينما في سورة النمل ففيها ثلاثة مؤكدات فقط في القصة كلها (أئنكم، لتأتون، وإنهم أناس يتطهرون). هذا الجو العام في السورتين
والوضع الوصفي فالآية في سورة الحجر أنسب مع الؤكدات في القصة من آية سورة النمل. وقد يسأل السائل لماذا؟ نلاحظ أنه تعالى وصف قوم لوط في سورة الحجر بالإجرام (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58)) أما في النمل فوصفهم بالجهل (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55))
والمجرمون أشد من الجاهلين فالوضف أشدّ وهذا الوصف الأشدّ يقتضي عقوبة أشدّ ول نظرنا إلى العقوبة في كلتا السورتين لوجدنا أن العقوبة في سورة الحجر أشدّ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74)) وفي سورة النمل (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58))
والمطر قد يكون ماء أما الحجارة في سورة الحجر فهي بالطبع أشدّ. إذن العقوبة أشدّ والوصف أشدّ ثم إن القصة في سورة الحجر (19 آية من الآية 58 إلى 76) أطول منها في سورة النمل (5 آيات فقط) فإذا نظرنا إلى القصة من جهة التوسع والإيجاز فآية سورة الحجر أنسب ومن حيث التوكيد والعقوبة والطول أنسب ولا يناسب وضع الآية مكان الأخرى. القرآن الكريم يراعي التعبير في كل مكان بصورة دقيقة ويراعي التصوير الفني للقصة.
د. حسام النعيمى:
في قوله تعالى في سورة الحجر الكلام كان على لسان الملائكة (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51)إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52)) الجو العام جو وجل وخوف من إبراهيم وتشكك، (قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53)قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54)قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55))
لا تيأس من رحمة الله (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56)) (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)) لاحظ التأكيدات هو يحتاج لمؤكدات لأنه وجل وشاك من الملائكة. تأكيد بإنّ وباللام. كلام الملائكة
لاحظ كلمة(قدرنا) هم لا يقدرون ولكن لأنهم وسيلة تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى رخصوا لأنفسهم أن يقولوا قدرنا ولكن ما قالوا قدرناها لم يربطوا الضمير بالتقدير، بأنفسهم لذلك أبعدوها مع وجود إنّ المؤكدة. فإذن كلام الملائكة يحتاج إلى تأكيد وإبتعد ضمير المفعول به في الأصل. الأصل هي قدرنا لكن أدخلوا إنّ فأبعدوها عن التقدير.
الآية الثانية هي من كلام الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النمل (فما كان جواب قومه فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) النمل) (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) خبر، (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ) ما قال قدرنا إنها،ما احتاج إلى تأكيدات لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأمر: بأن قوم لوط أجابوا بهذه الإجابة فالله سبحانه أنجاه وأهله إلا امرأته قدرها رب العزة من الغابرين.
وأُنظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشرة ما أبعده (قدرناها) لأن هذا قدره سبحانه وتعالى فما إحتاج إلى إبعاده. الغابرين قالوا بمعنى الباقين الهالكين الذين بقوا في الهلاك. نهاية الآية تفسر لنا كلمة (كانت) لما قال (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) )انتهى الكلام على ذكر الأمم، كان آخر شيء في ذكر الأمم يعني
لم تكن هناك حكاية ورواية لأمور وإنما رواية لهذه المسألة. النهاية كانت (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59)) لم يذكر أمة أخرى وراءها. هو لا يتحدث حديثاً تاريخياً متواصلاً وإنما إنقطع الكلام هنا.
آية (61):
*ما الفرق بين استعمال جاء وأتى في القرآن الكريم؟(د.فاضل السامرائى)
قال تعالى (فَلَمَّا جَاء آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ {61 الحجر}) وقال تعالى (يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً {43}مريم) وقال تعالى (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً {1} الإنسان).
إذا نظرنا في القرآن كله نجد أنه لم تستعمل صيغة المضارع للفعل جاء مطلقاً في القرآن كله ولا صيغة فعل أمر ولا إسم فاعل ولا إسم مفعول وإنما استعمل دائماً بصيغة الماضي. أما فعل أتى فقد استخدم بصيغة المضارع.
من الناحية اللغوية: جاء تستعمل لما فيه مشقة أما أتى فتستعمل للمجيء بسهولة ويسر ومنه الالمتياء وهي الطريق المسلوكة.
*ما دلالة الحروف (بما) و(لوما) في الآيات القرآنية؟(د.فاضل السامرائى)
(بما) للسبب وتقال للقسم أيضاً والسبب أظهر كما قال تعالى (رب بما أغويتني) أي بسبب ما أغويتني.
(لوما) إما أن تكون حرف امتناع لوجوب عندما تدخل على الأسماء أو يكون من حروف التحضيض عندما تدخل على الأفعال (لوما يأتينا بآية).
*هل يحق لنا استخدام كلمة (لعمري) الذي استخدمت في القرآن (لعمرك)؟ (د.فاضل السامرائى)
القسم بغير الله لا يجوز لكن يُسأل عن هذا السؤال فقيه لأنه من باب الحلال والحرام. وفي الحديث لا يجوز القسم بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
آية (68):
*في سورة الحجر (قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ (68)) وفي الذاريات (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24)) كلمة ضيف جاءت بالمفرد مع أن الملائكة مكرمين يعني جمع؟ (د.فاضل السامرائى)
كلمة ضيف تقال للمفرد وللجمع في اللغة مثلها كلمة خصم تقال للمفرد وللجمع (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) ص) وهذه ليست مختصة بالإفراد. وكذلك كلمة طفل تأتي للمفرد وللجمع عندنا كلمات في اللغة تأتي للمفرد وللجمع. وكذلك كلمة بشر (فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ (24) القمر) مفرد (بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ (18) المائدة)
جمع. عندنا كلمات تكون للمفرد وللجمع منها كلمة ضيف تكون للمفرد وللجمع. عندنا ضيوف وأضياف وعندنا خصم وخصوم وطفل وأطفال ورسول أيضاً تستعمل مفرد وجمع، ورسل، رسول جمع أيضاً تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمصدر أيضاً وهذا يسمى في اللغة إشتراك. الرسول تأتي بمعنى الرسالة والإرسال، المبلِّغ هذا الأصل فيها (فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) الشعراء) (فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ (47) طه) فإذن ضيف تأتي مفرد وجمع.
آية (74):
*ورد وصف عذاب قوم لوط مرة أنه وقع على القرية ومرة على القوم (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ (82) هود) (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74) الحجر) فما الفرق بينهما؟(د.فاضل السامرائى)
في الحجر (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ) وفي هود (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا) عليها يقصد بها القرية وعليهم يقصد بها الناس والقوم.عليهم يعني القوم وعليها يعني القرية يبقى سبب الاختيار. لا شك أنه لما قال عليهم معناها القوم وعليها يعني القرية يبقى سبب الاختيار هذا هو السؤال. لو لاحظنا الكلام على القوم في الموطنين كيف كان يتحدث حتى نفهم سبب الاختيار سنلاحظ أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود ووصفهم بصفات أسوأ مما في هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود: قال في الحجر على لسان الملائكة (قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (58))
وفي هود (إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70))، وفي الحجر قال (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (66)) وفي هود (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76)) العذاب هنا لا يقتضي الإستئصال أما في الحجر فهناك استئصال فما في الحجر إذن أشد مما في هود. أقسم على حياة الرسول في الحجر على هؤلاء
فقال (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)) ولم يقسم في هود. إذن ما ورد في الحجر في قوم لوط أشد مما ورد في هود وصفهم بالإجرام وأنه سيتأصلهم وأنهم في سكرتهم يعمهون فذكرهم هم (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً) ذكرهم هم ولم يذكرهم في هود فلما ذكرهم هم قال وأمطرنا عليهم ولما لم يذكرهم قال وأمطرنا عليها هذه أخف. أمطرنا عليهم أشد من أمطرنا عليها ذكر فأمطرنا عليهم في مقام الشدة والصفات السيئة.
*هل الماء والغيث كلاهما مطر؟ (د.فاضل السامرائى)
المطر يستعمله الله سبحانه وتعالى في العقوبات (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) الأعراف) لم يستعمل القرآن المطر إلا في العقوبة (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ (40) الفرقان) (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74) الحجر) (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (173) الشعراء)
أما الغيث فيستعمله في الخير. هذا في الاستعمال القرآني أما في الحديث فاستعمل المطر للخير ولكن للقرآن خصوصية في الاستعمال اللغوي نخصص لها إن شاء الله تعالى حلقات لنتحدث عنها لأنه موضوع كبير. والعرب فهمت هذا الفرق من الاستعمال. (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) الشورى). إذن في القرآن الكريم يذكر المطر للعذاب.
آية (75)-(77):
*قال تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75) و( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ (77) ما الفرق بين استخدام الجمع في الأولى والمفرد في الثانية. ثم انتقل إلى المثنى بعد الجمع(فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)؟(د.فاضل السامرائى)
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75)) هذه ذكرها تعقيباً على قوم لوط وذكر فيها عدة أمور قال (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73)) هذه آية، (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا (74)) هذه آية أخرى، (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ) هذه آية أخرى إذن هي آيات وليست آية واحدة لأن كل واحدة منها آية. والآية يعني العلامة والمتوسمين هم المفكرين المتفرسين والمعتبرين. في سياق القصة ذكر عدة أمور وعدة آيات وليست آية واحدة ذكر الصيحة وذكر عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة ثم قال (وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ (76))
أي الآن الآثار فقال (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ (77)) عندما تكلم عن الآثار هي آية واحدة (لآية) أما تلك فهي آيات. أما قوله تعالى (وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)) تكلم بعدها عن أصحاب الأيكة، إنهما أي قوم لوط وأصحاب الأيكة في طريق واحد تمرون عليهم. إمام أي طريق، تمرون عليهم بعد سنين أصحاب الأيكة وقوم لوط.
آية (82):
*(وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) الحجر) (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) الشعراء) ومرة ينحتون الجبال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (74) الأعراف)؟ فمتى نستخدم (من) ومتى لا نستخدمها؟ (د.فاضل السامرائى)
نقرأ الآيتين إحداهما في الأعراف والأخرى في الشعراء، قال في الأعراف (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74)) هؤلاء قوم صالح، في الشعراء قال (أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آَمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150)) نلاحظ في الأعراف مذكور فيها التوسع في العمران (تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا)
بينما في الشعراء الكلام عن الزرع وليس عن البناء، الكلام يدل على الزراعة أكثر (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148)) إذن في الأعراف السياق في العمران أكثر وفي الشعراء السياق في الزراعة فلما كان السياق في الأعراف في العمران ذكر (تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا) ذكر القصور وقال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) كأنها كل الجبال ينحتونها بيوتاً فتصير كثرة بينما لما كان السياق في الشعراء عن الزراعة قال (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149)) صار أقل (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ) أقل من (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا)
لذلك قال في آل عمران (فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74)) إذن التوسع في العمران في الأعراف أكثر فلما كان التوسع في العمران أكثر جاء بما يدل على التوسع قال (وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا) ولما لم يكن السياق في التوسع في العمران قال (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149)).
آية (88):
*ما الفرق بين فعلى الأسى والحزن؟ (د.فاضل السامرائى)
كِلا الفعلين يدل على الحزن عندنا حزِن يحزَن وحزَن يحزُن، حزِن يحزَن فعل لازم ليس متعدياً تقول حزِن عليه و(وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (88) الحجر)، (فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ (76) يس) (الكاف مفعول به).حزِن يحزُن متعدي، حزنني وأحزنني (قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ (13) يوسف). اللغة العليا حزَن يحزُن وتستعمل أحزن أيضاً، أحزن من حَزَن. الفعل أسي يأسى يسمونه الباب الرابع (لكيلا لا تأسوا) وأسى بمعنى حزن أيضاً (فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) الأعراف)
هي أأسى، فهو أسي يأسى، كلاهما يفيد الحزن لكن الفارق بين لكيلا تحزنوا ولكيلا تأسوا في الحزن مشقة أكثر وشدة لأنه قريب من معنى الحزْن الذي هو الغلظ والشدة في الأرض (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزْن إذا شئت سهلاً) الحزْن أي الصعب وتقال للأرض الصعبة. إذن الحزن فيه غِلظ وشدة في الأرض
والحُزن هو الغلظ والشدة في النفس. أيهما أثقل؟ الحُزن أثقل على النفس من الحزْن ، الحزْن تجتازه وانتهى الأمر أما الحُزن فيبقى في النفس. الحَزن فتحة والحُزن ضمة فاختاروا الضمة لما هو أثقل لأنها تتناسب اللفظة مع مدلولها أو المعنى .
آية (92):
*كيف نوفق بين الآيتين(فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) الرحمن) (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) الحجر)؟(د.فاضل السامرائى)
هذه مواقف مختلفة يوم القيامة الموقف الأول أنهم لا يُسألون مطلقاً ثم يصير السؤال، الموقف الأول خمسين ألف سنة لا يُسألون هذا الموقف قبل الحساب ثم يكون الحساب والسؤال (لنسألنهم أجمعين).
آية (98):
*د.فاضل السامرائى:
في القرآن نلاحظ أن الله تعالى يأمر بالإكثار من التسبيح والذكر في المواطن التي تحتاج إلى صبر وفي الأزمات (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) الحجر) وأمره بالتسبيح في قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) الأنفال)
ومداومة التسبيح تفرّج الكروب كما جاء في قصة يونس وهو في بطن الحوت (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) الصافات)
فالذي نجّى يونس من بطن الحوت هو مداومته على التسبيح (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)) والتسبيح وذكر الله هي أزكى الأعمال وأرفعها عند المليك. فهو ترتيب منطقي جداً بعدما تضيق الصدور والقلوب نذكر اسم ربنا.
الصفحة الأخيرة